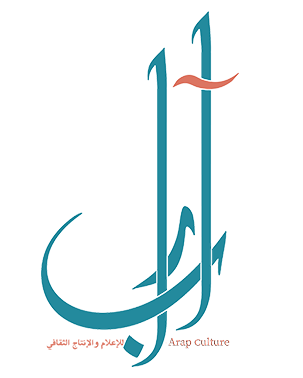إن حررنا الطيور.. من يحرر الجنود!
كم بلغت حقارة الإنسان؟ أتساءل فيما أفكر بصديقٍ، فرضت عليه الحرب التي لا علاقة له بها، أن يكون “وقوداً”، أن تكون سنوات عمره “وقوداً”، لا لشيء، فقط لأنّه لا سبيل لديه للسفر، ولا “واسطة” تدعمه أو تنتشله من الخراب الذي وقع فيه إلى وقتٍ غير مُدركٍ الآن. أشعر بثقل مسؤولية كهذه، رغم عدم جدوى هذا الكلام وتلك الأفكار.
كنتُ أكره في صغري رؤية عصفورٍ ما، يربيه أصحابه داخل قفص… كان يخطر لي فتح باب القفص، بشقاوة طفلة لا تتجرأ على فعل ذلك، لاتتجرّأ على ارتكاب الأخطاء الطفوليّة، بسبب ما كان يُغرَس فيها منذ بدأَتْ تعي الصح والخطأ وفق مفاهيم الأهل والموروث. وكبرتُ، وأنا أكره رؤية الطيور داخل الأقفاص.. أتألّم لأجلها، لا أبالغ إذ أقول ذلك، ولا أختلقه. أتألّم فأدير وجهي، لأنني لن أستطيع تحرير كل طيور العالم المسجونة بدءاً من الدجاج، وصولاً إلى الطيور الجارحة.
كم بلغت حقارة الإنسان؟ أتساءل فيما أفكر بصديقٍ، فرضت عليه الحرب التي لا علاقة له بها، أن يكون “وقوداً”، أن تكون سنوات عمره “وقوداً”، لا لشيء، فقط لأنّه لا سبيل لديه للسفر، ولا “واسطة” تدعمه أو تنتشله من الخراب الذي وقع فيه إلى وقتٍ غير مُدركٍ الآن. أشعر بثقل مسؤولية كهذه، رغم عدم جدوى هذا الكلام وتلك الأفكار.
أفكر في كيفيّة تحريرهم؟ أيجب على الجنود أن يتحرروا؟ أيجب على الطيور المسجونة أن تتحرر من أقفاصها؟ أم لابدّ للواقع أن يبقى فارضاً نفسه، تاركاً لكلّ ما هو غير متوّقع، غير مرغوب، حريّة الاختيار عن أصحابه، دون أيّ محاولة للاعتراض، أو قدرةٍ على الرفض أو تبديل وقائع الأمور.
ربّما كان علينا منذ البداية أن نقبل بأنّ الأمور تسير على هذا النحو، الطيور في الأقفاص، الجنود وقودُ الحروب، والمنفى يحمل تسمية “وطن”. وأنّ النقاش والتفكير، ها هنا، عبثيّ. “مُصابٌ باللشمانيا” ، يخبرني… بملامح باردة، حتى أخذ البرود البادي على وجهه هيئة اطمئنان تظهر للمقابل! لا، لم يكن ذلك قوّة بقدر ما كان بروداً، لا مبالاة، وربّما عبثيّة. هل تكون اللامبالاة، قوّة؟
كم يخسر الإنسان حتّى يصل إلى حالة كهذه؟ كم لملمَ من الخيبات والانكسارات؟ يطلب مني بقلق غريب: لا تخافي من “كورونا”. وكأنّه أدرك مخاوفي من المرض. أجيبه، ليس المرض هو المخيف، بل مذلّة المرض. يتابع كلامه: تحرري من هذه المخاوف. أصمت… إنّ حياة الجندي، صورة من صور الأَسْر.. حياةٌ تنقضي ببطء، على نار الانتظار، لا نيران البنادق وحسب.
إنّها سجنٌ بصلاحيات أوسع، تتيح للجندي الحركة أكثر، لكن كَدُمية معلقّة بخيوط متينة، يحرّكها القادة والرؤساء كما شاؤوا، خيوطها تُنسج باسم “الوطن”، ولا نصيب للوطن منها إلّا التبلل بالدماء و رائحة البارود وأشلاء الجثث.
كان يطلبُ مني، ما يفتقده في أعماقه، لا في حياته الحالية فقط. كنت أتمنّى لو أنّني تجرّأت في صغري لمرّة واحدة، وأطلقت عصفوراً ما، من قفصه.. لكنت حظيتُ بقصّة بطوليّة أرويها الآن! كم كانت قيّمة، وعظيمة قصص التحرير والتحرر من العبوديّة على مرّ التاريخ!، كم هي مهمّة!.
لكننا في بلد مثير للشفقة، لا نطمح.. بل لا نفكّر أصلاً في مصطلحات فخمة كهذه، في كلمات ومعانٍ يتفوّه بها “المثقفون” و “الفلاسفة”… ماذا يعني التحرر إن كنت خاوي البطن الآن؟. أمّا سائق سيّارة الأجرة، وبعد مفاوضات أجريتها معه من أجل الأجرة التي طلبها، وبعد حديثه عن أنّ سنواته في السعوديّة حرمته رؤية “جمال خلق الله” المخفي وراء النقاب و العباءات!، تلاه كلام مقتضب عن أزمة البنزين، وأزمة الخبز، اختتم أحاديثه غير المفيدة بنبرة استياءٍ و يأس: هذه بلدنا، حكمُ القويّ على الضعيف.
هل كان عليّ تحرير العصافير من أقفاصها؟ هل عليّ فعل ذلك الآن كلما صادفت قفصاً مُحكم الإغلاق؟ لكن إن حررنا الطيور.. من يحرر الجنود “المغلوب على أمرهم”؟ أولئك الذين لا يشبهون الحرب، ولا يمكن لرائحة البارود أن تعلق بهم.